النفس المُدمِّرة، والنفس البنّاءة، لا أدري إن كان أحداً قام بهذا التقسيم قبل فرويد، لكنه كان يحلل ظاهرة الانتحار، وأن المُنتحر يمارس أقسى صور التدمير. نرى اندياحًا وانتزاعًا فينا يذهب دومًا نحو الظلام، الحزن، القسوة، وكل صور الظلام التي يسعى الإنسان للفرار منها. يهرب منها الإنسان بشتى الطرق، عبادة مثال أعلى وأكمل، تزهُّد، متعة خالصة لا تنقطع، لكنه في أقرب بادرة لفشله يرجع فوراً للظلام والانكفاء.
اثنان يتحدثان، الأول مضحك ويقص حكايا مسلية، والآخر وَجْوُم وذا نَفَس سوداوي، ستجد الجميع يضحك مع الأول ويعجبون به، لكنهم ينسونه مباشرة ويتحدثون عن الآخر باعتباره يمثلهم، ويفهم دواخلهم. الكآبة بطبعها تغري بالكلام، بالتنفيس والحديث، بالبحث عن مشتقاتها خارجنا. جرب أن تقترب من أحدهم، ستكون أول مكنونات تكشّفه هي الحديث عن أحزانه وذكرياته التعيسة. هناك حاجة للكلام، للإخبار، لإفراغ كل هذا الحِمل المظلم داخلنا وتعريضه لأحد آخر بالخارج. بينما السعادة رغم اشتغالها في الجموع وحاجتها لأطراف خارجية إلا أن الاستئثار بها وبتفاصيلها يكون فرديّاً وبجشع ونهم، لا أحد يشاركها إلا مع أخص الناس لقلبه. الحزن يحتل وقتاً أطول من السعادة حين يحضر بمناسبته وظروفه، يعاملك بطريقة احتضانيّة، ويتصرف كثقيل الدم الذي لا ينصرف مهما تثاءبت أمامه. يجالس نهارك، وينام معك في ليلك. مشرّد لم يصدق أنه تلقى دعوة للمبيت، وسيفعل أي شيء ليطيل إقامته.
ربما استعذبنا الظلام لأننا نرى فيه فهمًا لنا، أُنْسًا يشعرنا أننا لسنا وحدنا. أنا أجلس وحدي في غرفتي، لكني حقيقةً أُجالس أفكاري، تجاربي، خيالاتي التي أستعذب قسوتها أحيانًا كماسوشية لم يفهم العلم دوافعها حتى الآن بشكل كامل. ما زالت قضية الانتحار تُحيّر التطوريين الدارويين وعُبّاد صنم المادة، مُنكِري ما وراء المادة.
لماذا ترتبط أشد مشاعرنا احتياجًا، بالحزن؟ لماذا الحب مثلاً لا يُستعذب إلا بالحزن؟
الحزن الحقيقي ليس باسترجاع لحظات جميلة والندم على أنك لم تستمتع بها، الحزن العظيم أن تعيش هذه اللحظات عالماً بجمالها ومدركاً لندرتها لكنك لا تستطيع الاستمتاع بها، هذا الشيء يقتلك قتلاً بطيئاً. ما الرابط داخلنا الذي يمتد منه حبل شعوري ولا يلتصق إلا بكل معاناة وقسوة وسبب لحزن؟ لماذا الحزن لا يذهب إلا بحزن أكبر منه وليس بسعادة أكبر؟ لماذا نتصور السعادة شيئًا طارئًا ومؤقتًا، بينما نعامل الحزن والسواد كأصل نعود إليه كما يعود المُهاجر مهما ابتعد؟.
هناك شعور يتكرر لكننا نسكت عنه، لا نستطيع وصفه، شعوراً أن المتعة مفقودة. تجد نفسك تعيش وضعًا مريحًا ظاهره الأُنس، لكن المتعة مفقودة وغائبة، هذا الشعور يختلط بشعورٍ آخر يعمل بك أن هناك شيئًا ما في ذهنك كواجب منسي لكنك لا تستطيع تذكر ما هو بالضبط. أشياء كانت تسعدك وتبسطك في حياتك، تجدها تفقد دفعة السعادة والنشوة التي كانت تمنحك إياها سابقاً. لعل هذا الشعور من أكثر المشاعر لدينا حساسية وغرابة ونخشى مواجهته، هذا الشعور يشبه الشيب والتجاعيد والضعف، حقيقة لا نريد مواجهتها وتصديقها.

وككل شعور نعيشه ونتشارك وجوده بنا، وتختلف مصاديقه وأسبابه، تظل هناك أسبابًا مشتركة لهذا الشعور.
حياتنا عبارة عن قفزات، حين تقصر القفزات أو تنتظم الحركة يأتينا هذا الشعور. نحن ندرس، والدراسة عبارة عن مراحل وكل مرحلة لها حماسها ونتيجتها التي ترفع معنوياتنا، وبعدها وظيفة ثم زواج، إلى آخر درجات الترقي الاجتماعي، وكل مرحلة سواءً أكانت مستقلة أو متداخلة مع مرحلة أخرى تظل لها قفزات، لكن في النهاية هذه القفزات تخبت وتقل وتضعف. بعدها تأتي الفكرة ويحضر السؤال، طيب وبعدين؟ نظل محصورين في فكرة وجودية، إلى متى نسير؟ بداخلك قناعة أن قفزات الإنجازات وما يعقبها من تحديات اختفت، تخيفك جداً وتحزنك هذه اللمسة العدمية لحياتك. بدأت تفقد تهاني الأهل والأصحاب على إنجازاتك، ولو حاولت أن تنجز شيئًا جديداً فسعتك النفسية وجهدك البدني سيصفعانك بغلظة، وينهاكا عن التشبب وتقليد المراهقين.
نقطة أخرى، الخوف من المستقبل، حين تكبر سننا وننتهي من طيش الطفولة وسماجة المراهقة نصبح مدركين لمعانٍ كالعمل والإنجاز ومعنى التعب، وهذا يقود لرهبة العمل وأنه قد يكون عبثيًا، نفكر بطريقة مستقلة أو من نماذج رأيناها أنه يمكن لكل هذا الجهد أن يكون عبثيًا بلا قيمة، ونتيجته مرارة جديدة، وتتملكنا فكرة أننا ربما أضعنا أجمل سنين حياتنا في مطاردة وهم، أو انغمسنا في تجارب استهلكتنا بلا مردود حقيقي، سواءً ماديًا أو عاطفيًا. هي مسألة وساوس وتخوفات، لكن تظل أسناننا صغيرة وتفتقد لتجارب التمييز أنه نوع من الرهبة غير المعقولة ولا المبررة. كل هذه الأشياء تسبب لنا تعاسة من نوع خاص وخفي. كذلك، حين ننطلق في حياتنا يتعاظم لدينا الشعور الأكبر بالاستقلالية وأني مسؤول عن نفسي ولم يعد هناك أحد كبير يعتني بي. كنا ونحن صغار ننام في الصالة على الأرض وآثار الزولية قد انطبعت ووسمت خدودنا، لكننا نفتح أعيننا لنجد أنفسنا في مراقدنا وأسرّتنا. دائمًا هناك ذلك الكبير، أعرض المنكبين وأشيب الفودين حسب الوصف الدارج للشخصيات المسؤولة في الروايات المترجمة بالخمسينيات، الذي يحملنا ويتولى الاهتمام بنا، صحيح أننا ننال من ذات هذا الكبير بضع صفعات حين نصر على السخافة ورد الصوت، لكنه كذلك يأخذنا للبقالة ويصرف علينا، يجعلنا ندخل البقالة كالغنم المنفلتة لنشتري أي شيء غير عالمين أننا هززنا ميزانية ذلك اليوم. فجأة وفي لحظة، لا ندري متى ابتدأت نجد أنفسنا لحالنا! كبرنا! صرنا رجالاً وحريمًا! عبارات كنا نقرأها مثل “كان في العقد الرابع من عمره” لنتصور مخلوقاً أسطوريّاً له أجنحة كالعنقاء يحلّق بها حين يريد أن ينجز مهمة ما حتى لو كانت الدخول للحمام، لكنك أنت تصير هذا الشخص، تنتبه أنك صرت في ذات عمره. تختفي تلك النضارة من وجهك، وتعتقد أن تعبك وإرهاقك سببه قلة اللياقة، وتظل تُمنِّي نفسك بتلك التمارين الخيالية التي ستفعلها لاحقاً في النادي وتستعيد بها قواك كمصارع روماني، لا تريد الاعتراف أن هرموناتك بدأت بالنضوب، وخلاياك لم تعد تتجدد كالسابق.
نجد أنفسنا كباراً نذاكر للدراسة دون رقيب يقف كالناطور فوق رؤوسنا ويصرخ فينا أننا فشلة. نفهم معنى الفلوس والمال والادخار، يصبح لدينا بداية إدراك كيف يعمل العالم وبأي طريقة يشتغل. لم يعد هناك أحد يأخذ أوراقي ويرتب أموري، أنا الذي أقوم بالتقديم والذهاب والسعي والبحث عن واسطة متأففة تمن علي إعطائي حقوقي، نفهم معنى حمرة الخجل وقسوة الطلب من اللئام، ويؤلمنا تذكر أن آباءنا مروا بمثل هذه المواقف لأجلنا ولم نكن نعلم حينها. حتى مواعيد المستشفى أنا الذي أرتبها، وأصير مسؤولاً عن أطفالي وأخواني الصغار كذلك.
هذا الشعور أنني انفصلت تمامًا عن محيطي السابق، مرعب، ونهرب من الاعتراف به. لهذا السبب نغوص ونستعذب ذكرياتنا القديمة، ونعيش بقية حياتنا نبحث عن هذه الجنة التي كنا فيها مخدومين ومحشومين. نهرب من الاعتراف أن الحياة تمضي وأننا نكبر، وأننا مكشوفون تمامًا بلا أي جدران للحماية. صرت أنت نفسك جداراً لمن هم أضعف وأصغر.

مسألة أخرى، تشتت مشاعرنا، كانت مشاعرنا بِكر ومحصورة في بيئتنا، لكن حين نكبر ونصل لتلك المرحلة اللذيذة، مرحلة منتهى انتفاخ الثمرة الناضجة ولمعانها، مرحلة العشرينات، نبدأ بالبحث عن سعادتنا خارج نطاق الأهل والأصدقاء. نتوق لحياة جديدة غامضة نسمع عنها في الشعر والرواية والقصص والحكايا والأفلام، وبذات الوقت نخاف من تجربتها وعواقبها. يختفي النوم المُطْمئِن، ونبدأ بالتعرف على ألعن قرين يمكنه مصاحبتك، النوم القلق ذا الأفكار المضطربة، تبدأ بالعيش في خيالات أو تجارب جديدة عليك. يتحرك فينا شعور الوحدة، وأننا نريد فعلاً أن نكون مع أحد نشبع فيه جميع رغباتنا العاطفية والجسدية. نكون هائمين بفكرة الكمال ورعب الكمال والبحث عن الكمال. نخاف من ذلك الذي لا يقدِّرنا ويفهمنا، وأيضاً نخاف من أن نلتقي بالكامل -في نظرنا- الذي لا نعرف كيف نتعامل معه ونحافظ عليه. دائمًا هناك شيء ما يقلق تفكيرنا بسبب تتوقاتنا لشيء جميل ننتظره ونرغب به، ومرعوبون من فكرة أننا لن نناله، أو نناله فنفسده بغبائنا المعتاد.
حتى مفهوم الصداقة يختل لدينا، كنا صغاراً نتعارك ونتساب ونتصالح، ولدينا فهم للحياة أنها أُنس وأكل وتمشيات، لكن نكبر قليلاً، ونعرف معانٍ غريبة ومخيفة كالحسد والمكيدة والاستغلال وعدم التقدير، الفكرة الوردية عن الحياة والصداقة تبدأ بالاهتزاز في نظرنا، وهذا شيء جديد يُضاف لخوفنا وشعورنا الدائم بعدم الاستمتاع. نشعر أن كل شيء عبارة عن صراع. صداقات الطفولة هي أعظم صداقات لأنها صداقات حقيقية بلا مصالح، لكنها بشكل ما تنفصم لأسباب كثيرة، ونبحث عن صداقات تشبهها، لكن الدنيا لا تسمح بذلك، الكل مشغول بمطاردة مصالحه والسعي لها مع انكفاء ذاتي لسبب بسيط، أنهم مثلك ومروا بما مررت به. وهذا سبب آخر يضاف لشعورنا بالوحدة. تريد تطبيق نظرية مارك توين أن السعادة لها طعم ألذ حين نمنحها ونكون سببًا فيها لأحدٍ آخر، لكنك متردد وتخشى أن عطاءك هذا سيرتد عليك ندامة.
أكثر شيء يسبب لنا القلق، ويشعرنا بوجود شيء ما خاطئ ويتركنا في اهتزاز نفسي مستمر، مطاردة الحياة، شعور أننا كبرنا أكثر من اللازم، ونريد فعل كل شيء، واللحاق بما يمكن اللحاق به، وبذات الوقت يتملكنا شعور التكرار، أننا نكرر كل شيء حتى لو كان شيئًا جميلاً في نظرنا. ندور بين فكرتين، هل أكرر شيئًا أحبه حتى أصاب بالملل منه، أم أجرب شيئًا جديداً؟ يوجد تناقض شعوري هنا، لأنه من الخطر تبديل الحصان في وسط السباق، هل أكرر شيئًا أحبه وأنحرم من بقية التجارب، أم أجرب أمراً مُبتكراً مع احتمالية خطر أنه سيستهلك نفسيتي وجهدي وعمري بلا مقابل؟ هذه فكرة خلفية تعمل في عقولنا دون أن ندركها، وتجعلنا نفتقد التركيز على متعنا اليومية. دومًا الشعور يخبرك أن هناك شيئًا ما غلطًا، لا تستطيع تحديده أو وضع أصبعك عليه، لكنك تقسم على وجوده وتأثيره.
أيضًا، القضية في مجملها شعورية ونضج، برؤية جانب مظلم من الحياة حين نشاهد والدينا يكبرون أمام أعيننا، وأقارب لنا يتساقطون بالموت ونحن واعون بمعنى الموت. هنا نرى الحياة بشكل جاد، والجدية مرادفة دائمًا للملل والكآبة والتخوفات، كما أن الجد في مفهومنا أنه ملازم للنجاح، لدينا عقدة أننا يجب أن ننجح ونثبت أنفسنا، كيف ننجح وما هو مفهوم النجاح؟؟ لا ندري، نعيش هذه الدائرة بوجوب النجاح، وفي ذات الوقت لا نعرف بالضبط ما هو النجاح. هل هو جمع المال، الحصول على شهادة، القناعة، الرضا، تحقيق أهداف ما، الخ (الأمثلة متناقضة بشكل مقصود).
الكلام هذا عام جداً، لأن هناك أناسًا يولدون في جحيم وفي يُتم وفي سياق غير إنساني، لكني أتحدث بشكل واسع ينطبق على النموذج العام. هذا ما يجعل الحزن حالة مستمرة، وحين يصاب بها الإنسان يشعر بها أنها لن تدعه، ولن تفتكّ عنه. تصير السعادة استثناءً، مكافأة نقبض عليها بكلتا يدينا كما نقبض على طير صغير كيلا يطير عنا. هناك حالات خاصة لأسباب الحزن حين يتحول لتعاسة، ثم لاكتئاب. الحالات الخاصة تعني وقوعات فردية لا يمكن تعميمها، وكذلك الحالات المرضية المرتبطة بأمراض واختلالات هرمونية ليس هذا مكان نقاشها أو التعاطي معها.
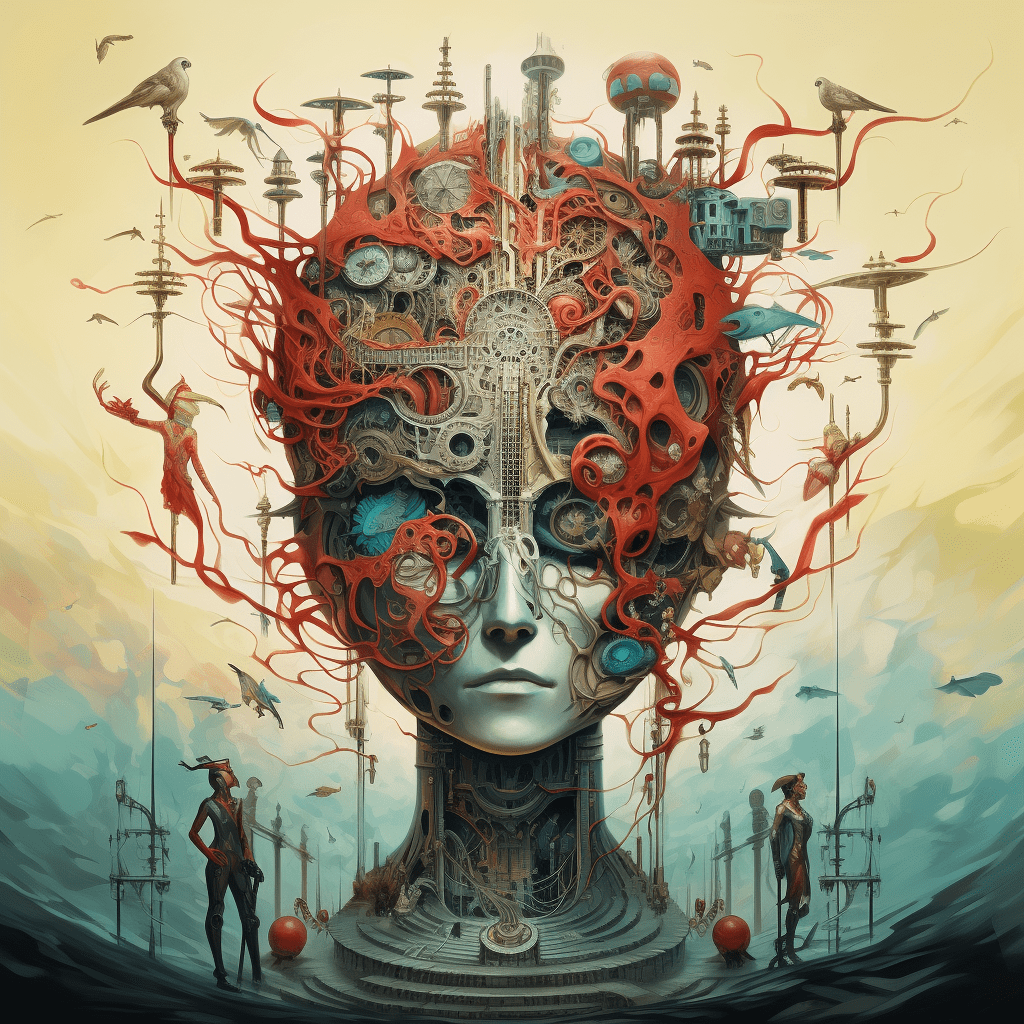
لكن ما هي السعادة، وأين توجد؟ فبأضدادها تُعرّف الأشياءُ، إذ أن السعادة لا يمكن تقييمها وفهمها إلا بمرجعيِّة معيارية وهي الحزن حسب تعبير أبو الوجدان الجمعي، كارل يونق. لذا، تحدث الفلاسفة عن السعادة كثيراً جداً، وككل شيء نسبي واعتباري، يصعب وجود إجابة مريحة يمكن الركون لها. فالحزن سببه قلة العمل والاستسلام للقلق ولا يمكن أن يكون الإنسان حراً ما لم يتحكم بنفسه، كلام أنيق من بيثاقوراس، لكنه ابن مجتمعه وبيئته التي تعتمد على العمل الجسدي المُنهِك، ونحن نتحدث عن مجتمعات يغلب عليها طابع الراحة والرفاهية، مما يجعلها مستغرقة أكثر في البحث عن السعادة الشعورية وبأسباب مادية. بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصًا في الخمسينيات برزت نغمة السعادة الاجتماعية، وخرج منظرون لها يبشرون أن السعادة ممكنة مجتمعيّاً وهي مادية بحتة، وهي تُختصر في وظيفة مريحة تدر مالاً كثيراً، وجنس. هذه فعلاً كلها تجلب السعادة وبوفرة، لكن هذه النظرة تنويع مشوّه للفلسفة الأبيقوريّة وبعض فلسفات المتصوِّفة الإسلاميين وغيرهم، لأن التنظير كان يلغي رحلة الإنسان الاجتماعية وتطوراتها، الإنسان الذي كان صيّاداً ثم صار مزارعًا ثم استقرَّ ثوريّاً صناعيّاً مخموراً يرجع لبيته ليضرب زوجته ويشكي الفاقة.
هذا التنظير للسعادة أغفل اختضاض تربة المجتمعات وتقسيماتها الجندرية، وثبات الرجل في كل مراحلها وتغير وضع المرأة المستمر، مما شكل تغيرات مستمرة للأسرة النووية، مركز تنشئة السعادة، وهذا يُبعِد وبشكل فوري صلاحية نظرتهم الاجتماعية للسعادة، لأن السعادة تحتاج لاتزان، لهدوء، لثبات معين حتى تعمل بكفاءة ويُستلذ بها دون خوف من انقطاعها في لحظة. إذا نظّرتَ لشيءٍ فيجب أن يُعمم، لا أن يقرئ في أفراد.
هل السعادة في الدين؟ وإذا كان نعم، فلماذا تتغير الأديان والتشريعات؟ حتى لو كان الأصل واحداً إلا أن العبرة بأثره وقانونه، وكل حضارة لا يمكنها العمل والنشوء والتغلّب بلا عقيدة وعمل، والعمل هنا المقصود به القانون والتشريعات المحلِّلة والمُحرِّمة. لو كان الدين مصدراً للسعادة لرأينا معظم العالم سعداء، لأن النفاة الملاحدة هم أقلية. بل سنجد نُفاةً سعداء.
كيف يمكن استجلاب مصدراً للسعادة يخفف من وهج السواد والظلام في دواخلنا؟
لعل الحزن هذا كله في داخلنا، والظلام، هو دافع للبحث عن نورٍ ما، نوراً خارجيّاً لا تنطبق عليه مفاهيمنا المادية. ولا أقصد بذلك تأملات الخاشعين الذين عرفتهم كل عقيدة، بل بالبحث عن نور مُتغلِّب، قاهِر، حضوره ذا طابع اجتياحي تُفقد في حضوره حتى الظلال، هل نبحث عن الله؟ ولو أردنا البحث عنه، فنبحث بأي طريقة؟ أم أننا سندخل في تناقض العقل الشهير:
“The brain is the most important organ according to the brain.”
نحن مؤلِّهين، إذن الحل يكمن في الإله. كيف عرفنا هذا؟ لأنه هو قال لنا ذلك! سندخل في مُصادرَة على المطلوب، وهو أكبر تناقض عقلي نقع به في حياتنا اليومية دون أن نعي.
علماء الأعصاب يتحدثون عن العقل ثنائي الحجرات، وهي تسمية لطيفة حتى لا يُعيّروا ليقولوا أن عقولنا تحوي مادة مهمتها أن تبحث عن ما وراء المادة، تبحث عن صوت الإله. باختصار، يتحدثون عن الوعي الإلهي الذي يفر منه الجميع. من عارض فكرة الحجرات ذهب لنظرية النواة المُخيّة التي من وظيفتها ضمن وظائف عدة أن تبحث عن الله، ليس لأن الله موجود بل لأن مخك مصنوع بهذه الطريقة! طيب من بنى مخّي؟ أحداً لا يجيب عن ذلك.

السعادة لها طبيعة انتشاريّة، إغرائيّة، وهي تحضر بين الجميع حين يتقاسمون مفهومًا موحداً للسعادة. حين يتضخم المفهوم فالأثر يبقى أكثر، لكن لأن الفلسفات والعلوم ليس لها مفهوم موحد للسعادة، ولأن لهم حضور مكثف في تحديد مشتركات التعاسة والحديث عنها بكثرة، ومنها هذا المقال الكئيب، نجد أننا في بيئة مريضة ومُعدية. نتحدث عن ترسبات آلاف السنين في وعينا الجمعي عن التعاسة، وتوارثها، وانتقالها لنا. المزاج الإنساني بشكل عام نكدي، ويميل لتذكر مصائبه ويؤرخها، يسترجعون في أوروبا سنة الموت الأسود والتي نسميها في نجد سنة الرحمة. الهنود يتذكرون سنة حروب ملوك الراجبوت باعتبارها سنة نحيسة عليهم، وتسببت في فرقتهم وتشتت تماسكهم الاجتماعي بما مهّد لغزو محمد الغزنوي لهم. في تراثنا الإسلامي نجد عام الحزن، وهو العام الذي فقد فيه الرسول الأعظم زوجته الحبيبة خديجة، التي نالت شرف أن تكون أم أولاده وبناته، وفقد فيه عمه الذي ناصره ودافع عنه.
حتى العلوم الحديثة صارت تحارب السعادة، يخبرك العلم أن السعادة المستمرة ستسبب انقراضًا لنا لو بقينا تحت مفهوم واحد للسعادة واستمرينا به وصار الحزن هو الحلقة الأضعف وذا حضور مناسباتي فقط فالإنسان حتمًا سينقرض، وسيغيب عنه دافع البناء والمُجاهدة. مفهوم تراه جميلاً من بعيد ومتماسكًا، لكنك حين تقترب منه ترى به تشققات التناقضات. صار الجميع مدمنًا على الدوبامين، ولا يفهم أن سعادته في السيراتونين. الدوبامين يحضر بنفسه ولا يُستجلب، بينما السيراتونين هو المكافأة الحقيقية التي نعمل لأجلها، التشوه وصل حتى للمفهوم العام. الجميع يظن السعادة في الدوبامين! وصاروا في دائرة إدمانية لا تنقطع عن كل المتع الحسية.
مرة أخرى، نجد أننا نفهم الظلام ونرى فيه عذوبة نكرهها، لأننا نشعر أننا نستبدل شعوراً بشعورٍ آخر، لأن العدم لا يعمل في النفس، فالنفس يجب أن تشعر بشيءٍ ما قهراً. يشبه الأمر مدمني التسوّق، وكأن المال طاقة يجب أن تتبدد، لدينا شعور موجود بداخلنا كمجال وحيّز. لا يمكننا بناء حواجز عن الحزن، لأن هذه الحواجز ستمنع عنا السعادة كذلك حسب تعبير جيم رون.
ربما نحن لا نفهم السعادة فضلاً عن العيش الدائم بها لذا فنحن عايشنا الظلام، حتى ألفناه وأحببناه، بل ورأينا فيه رومانسيةً ما.
ا.هـ

