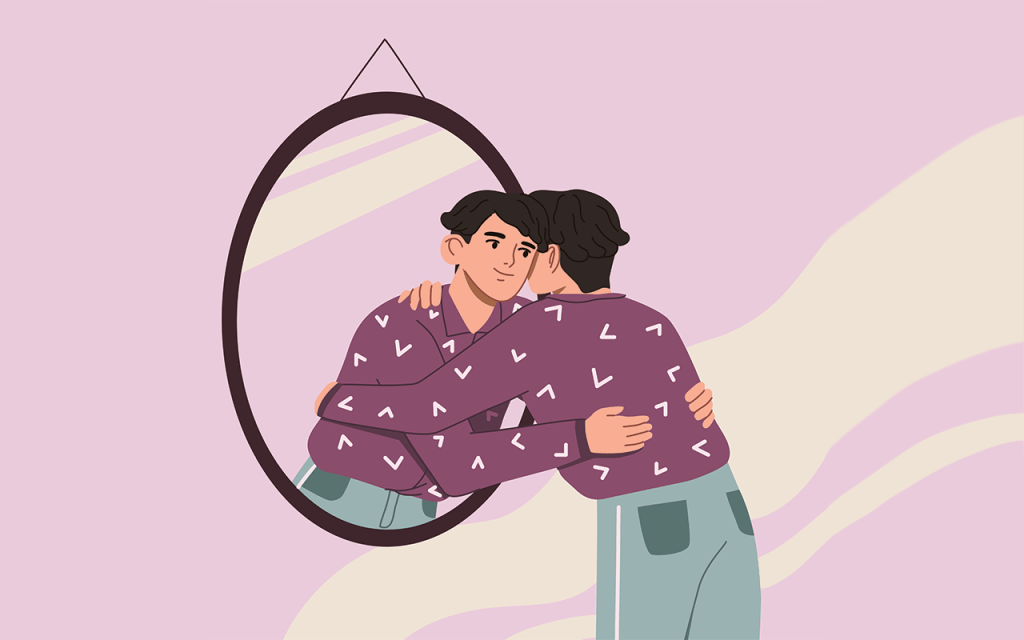يستطيع كل أحد أن يمارس دور المُقيّم حين يقيّم كل من حوله، أن يعطي انطباعاته التي لا تنتهي عمن يخالطهم ويعاشرهم، له في ذلك تقييمات مُحدَّدة تشبه تلك الاستبانات التي تخص خدمة العملاء حيث أنت راضٍ جداً وتنصح بهم، أو مغتاظ جداً وتتمنى لو تحترق تجارتهم. هذه التقييمات التي كوّنتها حول أصدقائك وزملائك بل وحتى أهلك تقوم على التجربة التي أدت لمعرفة ما، وعمومًا، هذه المعرفة تبقى في النهاية مجرد رأي يُشكِّل منظورك تجاههم، وهذا الرأي له تأثير ما عليك وعلى من حولك، فالتفاعلات الإنسانية تمارس طريقة التموّج واهتزاز الخيوط المشدودة، حيث بقوة التفاعل أو ضعفه ينتج هذا التأثير أو ذاك.
التناقض يحدث حين يختل معيار التقييم، إذ لا توجد معايير حدِّية ثابتة يمكن الركون لها، بل هي أحكام اعتبارية ومسميات اعتباطية تُبنى على ما نراه نحن خيراً أو شراً، صوابًا أو خطأً، قيمة محمودة أو مذمة مرذولة، لكن في عمقها هي تدور حول مصلحتنا ومنفعتنا أو ما يضرنا ويؤذينا، فبكمية المنفعة المادية والمعنوية ترتفع قيمة الأشخاص من حولنا، وبمقدار ما نراه ونعتبره أذىً تهبط أسهمهم لأسفل سافلين، فكل واحد منّا لديه تلك القناعة الراسخة أنه محور الكون وسيّد المشارق، ورأيه حقيقة ومعصوم وبه تُعرَّف القيم، لدينا رغبة لعينة اسمها رغبة التغيير، وحيث أننا مقيدون بأحزمة دينية وسياسية ومالية واجتماعية تُخبِرنا بحجمنا الحقيقي، فنحن نلجئ للقدرة الوحيدة التي نظنها ممكنة للتغيير، إبداء الرأي. طبيعة بشرية نمارسها جميعًا، لكننا نختلف في حدتها وكميتها، راقب ذلك الذي يبدي رأيه في قضية سياسية أو مذهبية شائكة وستفهم قصدي، المهم، حين يسألنا أحد عن شخص ما، فهل أنت تعرف تمامًا هذا الشخص حتى تسِمهُ بوصفٍ أو رأي ما؟ أنت تحكم عليه بما يظهر لك منه، وبنوعية التجاذبات بينكما، وبكمية المشاعر المتكونة تجاهه، ومقادير الانجذاب والتنافر التي تحدث لأسباب لا يمكن تفسيرها دائمًا، ومهما يكن رأيك في شخصٍ ما فستجد من يخالفك الرأي دومًا، وكلاكما ذا رأي له اعتباره ولا يخلو من صحة. لستُ من فرقة المُصوِّبة حيث كل رأي هو رأي صحيح! لكن ولأن مناظيرنا تختلف، فآراؤنا كذلك تختلف، والجميع يحكم من زاويته التي يرى منها.

هنا يبرز السؤال الأهم، كيف نحكم على أنفسنا؟ كيف نكوّن ذلك الرأي الذي يخصنا عن أنفسنا، فنحن جميعًا لنا تلك الصورة الوردية التي انطبعت في عقولنا عنَّا، اسأل أحدهم عن أعظم خطاياه وذنوبه، سيقول لك بوجهٍ ضامر تكسّرت حواجبه أنه بريء أكثر من اللازم، ويثق في الناس أكثر من اللازم، ويُعطي ويمنح أكثر من اللازم، وأن كل فشل في حياته مردُّه طيبة قلبه وسذاجته لأنه مشغول طيلة الوقت بمداعبة القطط الصغيرة. يمدح نفسه من حيث يريد ذمها، ويرى في نفسه الاكتمال من حيث لا يمكن اللحاق به لذا هو لا يمكنه الاندماج والانسجام معنا نحن الأشرار الذين نحيط به، لهذا فالمصائب والمكائد تطارده بإصرار منا. نحن نخدع أنفسنا باستمرار، ولا خداع يعتبر مطلقًا إلا خداع النفس للنفس حسب وصف سورين كيركيقارد.
يوصف الإنسان الذي يحكم على الآخرين بلا معرفة كافية أنه كاذب، ومُستكثر بما لم يُعط، وشهادته تُرد عُرفًا وشرعًا، لأن الحكم على الناس بلا معرفة لها أدوات يقين المخالطة ومدافعات المُداخلة، تجعل الحكم مرفوضًا وغير صالح. لكن حين يأتي الأمر لأنفسنا فنحن لا نطبِّق هذه الشروط تجاه أنفسنا، نقبل الحكم عليها بلا أي أدوات متجردة أو موضوعية، ورغم استحالة الموضوعية، إلا أن أدنى درجاتها تُفقد عند الحديث عن النفس ومواجهتها. يصيب الإنسان ارتباك ما حين تُطلب منه شهادة أو تزكية عن أحدهم، فهناك الرهبة وهناك الرغبة، رهبة أن نقع في شنآن القوم وربما أصابنا من ذلك محاسبة أو انتقام، أو تتداخلنا رغبة التزلف والتقرب وظن العطايا، وبينهما يقع الصدق، صدق الحديث والرأي المُعتقد. فالحديث هنا كله عن الحديث الصادق بغض النظر عن اعتقاد صاحبه وأدواته، أما من له مصلحة أو غاية يلحقها في الآخرين، أو تتركّبه نرجسية تجاه نفسه فهؤلاء لا يمكن الحديث عنهم، لأن الحاجة أم الاتجاه، والمصلحة سيدة اللسان والجنان. الحديث هنا يتم عن تلك الرغبة الصادقة التي تتملكنا أحيانًا، لماذا نظن أنفسنا غامضين، لماذا نتساءل دومًا أننا لا نفهم أنفسنا، لماذا تصيبنا معرّة وغضب حين نسمع من يقيّمنا رغم ملاصقته لنا ونقول أنت لا تفهمني، أنت لا تعرف دواخلي، نعيش في حالة تبرير مستمر للخارج بينما الداخل مُهمل تمامًا ونجهل كل شيء عنه.

حالهُ غريبة، في كل شيءٍ له رأي، يتحدث في الاقتصاد كأحد أبناء روكفيلر، وحين يتكلم في السياسة يحاول إقناعك أنه تشرشل عاد للحياة، يفهم في النقد الأدبي ويستطيع إبكاء ابن المقفع من سلاطة لسانه، في الشرع هو مفتي الكون ويعرف اتجاه القبلة في كل مجرة، لكن حين يخصه الأمر، يقول لا أدري لا أفهم نفسي! وكأن معرفة النفس لها من التلغّز والطلسمة ما يجعلها حالة مستعصية تمامًا، ونخالف وصية نيتشه الذي كاد أن يبكي وهو يرجونا أن نغوص أكثر في أنفسنا لنعرفها، وكأنه يتحدث عن الهروب، عن البقاء على شفا النفس وحدودها والخوف من التعمق بها، لأن ما سيواجهنا بداخلها ربما فاجئنا بحقيقة نهرب منها.
نقرأ جميعًا تلك العبارات الركيكة لغويًا والساذجة معنويًا، والتي تمارس نوعًا من الشحاذة الأخلاقية والتسوّل العاطفي، عبارات تتهم الجميع بلا استثناء بالقسوة والغدر، وتطلب من الجميع أن يكونوا سمحي النفوس، عاليو الأخلاق، طيبو المعشر، وكأن الناشر لهذه العبارات يشحذنا أن نعامله هذه المعاملة لأنه أضعف وأسخف من أن يتصبّر ويفهم كيف تعمل الحياة، وكيف يمشي قانون التدافع بين الناس. أنفس ضعيفة وهشة لا تستطيع المواجهة فتختار أن تعتاش بعقلية الضحية، وتحكم على الجميع وتصنفهم برأي واحد أن الجميع أشرار حيث كان يجب عليهم أن يكونوا أضعف منا ويخدموننا طيلة الوقت.
الواقع غير التوقّع، نضع دائمًا صفات محددة نتوقعها حسب التصنيف، زملاء، عائلة، أصدقاء، أحباء، أوِدّاء، الخ ثم نفترض طريقة معينة في تصرفاتهم وكيف يتصرفون معنا، من أقنعنا بهذه الشروط؟ من أقرّها وبشّر بها وجعلها ركنًا للصواب؟ لأن تصنيف الناس يقود المُصنِّف -قطعًا- أن يضع نفسه في رأس القائمة وضمن المتميزين بالضرورة، وهذا يلغي فوراً موضوعيته، كما أن هذه الطريقة المُعاقة للتقييم تُغفل المقاييس المتشابهة والظروف المتقاربة.
التقييم والاختبار يعني الأستاذية، وأن المُقيِّم له من الدراية والحكمة والمعرفة ما يجعله يستطيع التفريق فعلاً، وإذا كان هذا صعبًا جداً في ظروف دراسات “موضوعيّة” كالعلوم الطبيعية ذات القوانين التي لا تتخلّف، فكيف يمكن إسقاطها على الظروف “الذاتيّة” المتغيّرة بلا قانون يضبط ويتوقع ردات فعلها؟ وأقصد هنا النفس الإنسانية. معرفتنا للناس نستقيها من خلالنا وتعاملهم معنا فقط، وهذا مرة أخرى يلغي الموضوعية، لذا يصعب أن ننظر بموضوعية لأنفسنا إذا مارسنا ذات النظرة تجاه الناس تجاهنا. والاستغراق في مثل هذه النقودات تجاه الغير مع إهمال النفس يفسد النفس ويفسد الجميع معًا، لأنها عملية ذاتية إذا مارسها الجميع صارت كالوباء، بينما نقد النفس الذاتية ومعرفتها يقودنا حتمًا لصلاح النفس وما في مجموع كل هذه الأنفس لصلاح المجتمع، أي مجتمع ولو بيت صغير، كاملاً.
(وفي أنفسكم أفلا تبصرون) بعد أن ذكر آيات الأرض وألحقها بآيات السماء تحدث عمن بينهما، الإنسان، ودعاه للاستبصار في نفسه، دعوات مكررة للتعمق في النفس، لكن أين الصعوبة في هذه الدعوة، ولم هي تبدو عصيةً أحيانًا؟
الإنسان في مواجهة الإنسان، ندٌ لِنِد، حين تواجه أحداً فأنتما نِدان يتصارعان بالأفكار، ويمارس الجميع محاولة القهر والجبر والنزوع نحو التسيّد، فهذه طبيعة المُدافعة، لكن هذه الطبيعة ورغم وجود غالب ومغلوب وتبدل النهايات، إلا أن بها عنصر النِّدِّية، لكن الإنسان في مواجهة نفسه من يواجه؟ هل الإنسان ندٌ لنفسه، وبإزاء ماذا؟
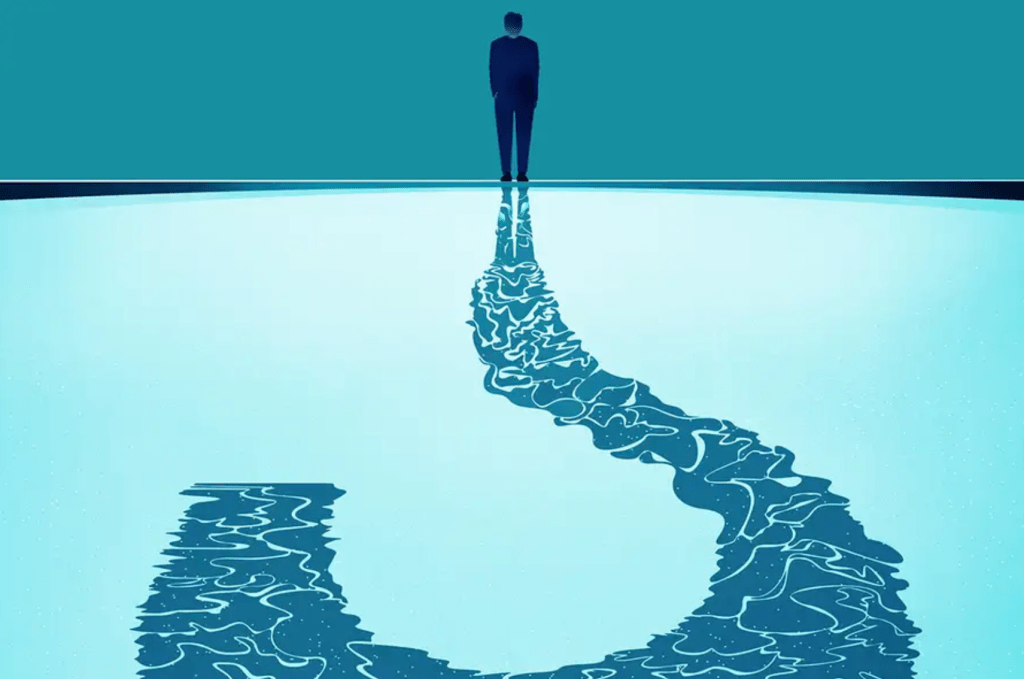
مشكلة الإنسان التي تقترب لأن تكون معضلة، أنه حين يواجه نفسه فهو يواجه فكرة، ومواجهات الأفكار الذاتية من أصعب المواجهات، لأنها مواجهةٌ سلاحها منها وبها وفيها، فأنت تُحاكم فكرة تتغمّسك، وتصارع فكرة تحكمك فعلاً، وكل حجة ترد بها عليها هي نابعة منها، تتصرف بعض الأفكار كالخلايا السرطانية حين تهاجم نفسها وتتضخم، أو كالأمراض المناعية حين يهاجم الجسم نفسه وخلاياه باعتبارها مخلوقات غريبة وخارجية. هذه هي صعوبة أن نواجه أفكارنا الخاصة، أن نستطيع وبدقة جراحية فائقة أن نعزِل الفكرة ونقطعها عن جذورها لإعادة تصنيعها في ذات موضعها، عملية ترميميّة، فطرد فكرة من العقل مستحيلة عقلاً، فتكون المواجهة ذات صخب نفسي عالي التأثير والنتائج. لا توجد فكرة تعمل لوحدها، هي تحيا وتقوى بالجذب والتراكم، تجذب أفكاراً غيرها داخلك وتحولهم كما يغير المبشّرون والدعاة عقائد البشر. الاستسلام لفكرة وحيدة ومسيطرة باعتقادك أنها سراً يخصك لا أحد يعلم بها، سيحولك لإنسان لا يُفهم، وكل شيء يدخلك سيخضع لتلك الفكرة مهما ادعيت الموضوعية.
هذه الحالة من الصعوبة في مواجهة الأفكار الداخلية هي ما يجعل مواجهة النفس، ومحاولة فهمها، عملية مقلقة للطمأنينة، وتسحب السكينة، وتضطرب بها السلوكات. لا يمكن لفكرة متجذرة وذات أصل نفسي بنائي أن تتغير في صمت ودعة، ولا أدلَّ على تغير الفكرة من تغير السلوك الذي يخضع دومًا لحاكمه الفعلي، العقل.
من يريد مثل هذه المعركة؟ من يرغب بمثل هذا الصداع الذي لا ينتهي، ولأي غاية؟ فهمت نفسي، ثم ماذا؟
يبدو في تحليل القضية أنها تحمل صعوبات كثيرة، ولعل أبرزها قضايا الدوافع والمواجهة والغُربة. ثلاث قضايا، تبدو كعثرات حقيقية لفهم النفس واستصعاب التوافق معها.
لا يمكن للإنسان أن يفهم نفسه دون أن يفهم دوافعه، أن يعرف سبب تلك الكلمة التي قالها، ذلك الفعل الذي صنعه، أن يصارح خبيئة نفسه لماذا ضحك لهذا وعبّس لهذا، لماذا تعذّر بالتعب عن ذلك النشاط لكنه قفز لنشاط آخر، نمارس أعذاراً لا تنتهي عما نريد وما لا نريد، ونحن صادقون فيها ظاهريًّا، لكن في جذر السبب الداخلي تكمن إجابات أخرى نهرب من سماعها. فالفعل يتخافى بتواضح الدافع، ويتضّح بخفاء الدافع، علاقة عكسية دائمة الدوران. فنحن لا نهتم كثيراً بانفضاح عملنا، ترعبنا فكرة أن يعرف أحد دوافعنا. فمثلاً، ما نريده فعلاً لا نقوله، نلمح له بكلماتنا، نلوح به في مزحاتنا، يظهر في انفجاراتنا غير المفهومة. ما نريده فعلاً، نحفظه مقفلاً عليه مصفّداً في دوافعنا التي نعرضها متنكرة في كم طوفاني هائل من التصرفات العشوائية حتى لا يُكتشف.
هذا الدافع يحتاج للمواجهة كنتيجة حتمية، لكن القضية ليست في المواجهة باعتبارها حتمية فعلاً، بل هي يجب أن تكون مرحلة لاحقة من الاعتراف بالدافع برغبة التصادم مع أعظم مشاعرنا السيئة، الخزي. لو لم يكن الدافع مخزيًا في نظرنا لما كتمناه في دواخلنا، ولتحدثنا به صراحة أمام الجميع وبتفاخر، لكن شعور الخزي يرتبط دومًا بدوافعنا لاعتقادنا بسرية وخصوصية أفكارنا، نعتقد أننا الوحيدون الذين يفكرون بهذه الطريقة أو تلك. لا أحد يتحدث فنفترض أننا لوحدنا المتورطون في هذه الفكرة. الخزي شعور يستجلب معه الهروب والتلطيف والتبرير المستمر، وما في هذه الأساليب من إرهاق نفسي لا يمكن تحمله، وسيتم التنفيس عنها في انفجارات لفظية، وتجاوزات سلوكية، وخشونة اتصاليّة مع من حولنا.
الخزي ليس مرضاً حتى يمكن علاجه، أو التخفيف من أوجاعه، بل هو شعور كامل له جذر ونمو ونتيجة. ولا يمكن نزع الخزي من أنفسنا إلا بالقناعة أننا لسنا وحدنا في هذا الشعور، وأن دوافعنا طالما لم تحمل أذى لأحد فخزيها غير صادق، بل هو خزي متوّهم، كمن تصيبه حكة تحسس على جلده فيكون أول استنتاج له أنها بداية جذام، فيعتزل من حوله باعتباره قنبلة وبائية لن يتقبّل وجودها أحد.

لكن الاستغراق في رحلة النفس ومعرفتها يقود لما أعتبره أشدها وطأة عليها، الغُربة. تخيل معي ذلك الدكتور الذي قضى سنواته الجامعية يدرس الفيزياء، ثم بعد تخرجه أكمل دراسة الماجستير في تخصص الفيزياء النظرية أو الكونية، ولأن الأمر يروق له ولأن الجامعة تلزمه بإكمال تعليمه، فهو يتخصص في دراسة الدكتوراه ليبحث في المادة المظلمة أو نظرية الأوتار. يعود هذا الدكتور بعقل يكاد ينفجر من كمية المعلومات والمعرفة التي اكتسبها، لكن القسم يقرر له أن يدرس الطلبة المستجدين في قسم الفيزياء، لديه نصاب كامل من مقرري 101 و 105 فيز ومطلوب منه تدريسهما والتعامل مع صغار الأحلام.
هذا الدكتور حين يتحدث مع طلبته في مقررات مدخلية للفيزياء، سيستطيع شرحها لهم، سيتمكن من الحديث معهم، لكن لا يمكن له أن يشعر بالتواصل، هناك هوة معرفية قبل أن تكون مسافة علمية بينهم، لا يمكنه الاندماج ولو أراد. هذا الدكتور عاش ما لا يقل عن عشر سنوات يبحث في أعمق مسائل الفيزياء، والآن مطلوب منه أن يتناقش مع طلبة لا يعرفون بور أو شرودينقر أو ماكسويل أو فاينمان وغيرهم، كيف ستكون لغة التواصل المعرفي بينهم؟ هو يشعر بغربة وانفصال تام عنهم، ولا يندمج معهم إلا بالحديث عن مشتركات حياتية كالطعام والأفلام، لا يمكن لومهم، فلو أردنا المقارنة بينهم فيجب مقارنة هذا الطالب بأستاذه حين كانا في ذات السن الحيوية والمعرفية، أما المقارنة في هذا الوضع فتبدو ظالمة وتفتقد للإنصاف، وستكون تنويعًا لاختبار الهراء الذي وضعه بينيه وطوره شتيرن باعتباره حُكمًا للذكاء الإنساني.
لكن هذا الطالب الذي لا يزال يتحسس طريقه في الكلية سيصل، حتمًا سيصل، وسيكون أحد هؤلاء التعساء الذين تضرِبُهم سَنَة النوم في المحاضرات زميلاً لدكتورهم بعد سنين عديدة، لكن هذه الرحلة ستحتاج لغُربة تخصها، لابتعاد عن كل مُشوِّش آخر والتركيز على الفيزياء. لأن المعرفة، أي معرفة، تغيّر منظورنا وتطوره، وبتغيّر المنظور تختلف نظرتنا تجاه الحياة والناس وكل شيء. لهذا السبب تمتلك بعض الأفكار قدراتٍ فتكيّة وتدمر حرفيًا مفاهيم عشناها وتبنيناها وآمنا بها لسنين طويلة. لو نقلنا مثال الفيزياء نحو النفس فسنجد أنها نفس الرحلة، جدية في التخصص ورغبة في خوض هذه الرحلة، ثم انفصال تام عن كل شيء آخر يمكن له أن يتداخل مع فكرة الغربة، ففي النهاية الغربة قرار نابع من فكرة.
في رحلة الشعور والانغلاق في حدودها التي لا تتوقف، يتجدد المنظور في وعينا، وكما أن تجارب الحواس تزيد من معرفتنا وتؤثر في حكمنا، فكذلك الشعور بأدواته يأخذنا دومًا في أشد أبعاده ليرينا وبشكل متدرج ما نفهم منه أعظم معرفة وهي معرفة النفس للنفس وإدراك وجودنا بالوجود. لم يكف العارفون والمتصوفون لحظة عن الحديث عن معرفة النفس للنفس باعتبارها أرقى معرفة ممكنة وأجودها وأعظمها حيث يتحدا العالِم والمعلوم. وتحدث الفلاسفة عن إدراك الوجود بالوجود بعد أن يأسوا من تعريفه واعتبروه شيئًا غامضًا بلا هوية وغير قابل للسحب من العقل نحو عروض خارجية تُصدِّقه. فكذلك النفس والاستغراق فيها وربطها بالوجود، ينقل صاحبه حين يعبث في جدران وعيه، ويفهمها بتجرد أصيل وصادق، نحو أفهام جديدة، وهذه الأفهام تغيّر منظور صاحبها تجاه نفسه قبل غيره.

مواجهة النفس يستدعي نقدها، لذا يخسر النرجسيون هذه الصولة من معرفة النفس، لأن النرجسي يرى في نفسه الكمال المطلق، ولا يحتمل النقد مهما كان صائبًا، وهذا ما يجعل النرجسي غبيّاً لدرجة البهيمية على المستوى الإنساني وإن كان مبدعًا في مجالات أخرى غير إنسانية. معرفة النفس ليست قراراً يُتخذ بحماس في لحظة نشوة، بل هو نشأةً أُخرى للنفس، حين تبدأ فلا يمكن لها أن تقف، ومن بداها بصدق فلن يتوقف، سيمر بدايةً بأصعب أحوال النفس وهي النفس اللوّامة التي تدعو للاعتراف والتغيير على أمل وصوله للنفس الأخيرة، المطمئنة. هذه المعرفة وغربتها، ستصنع لصاحبها انفصالاً وابتعاداً عن الجميع، سيجد نفسه في نفسه، وسيبحث عن كل شيء في نفسه، ستكون معرفة منقلبة للداخل وتبتعد عن ضجيج الخارج وصخبه وشواشه.
ا. هـ.